
كتب دكتور إبراهيم عامر
مقدمة:
يحاول هذا المقال إعادة طرح ما يعرف بتكاملية الفنون أو تداخل الفنون؛ وذلك من خلال دراسة تأثير الخطاب السينمائي بتقنية المونتاج في الخطاب الروائي العربي، فتداخل الفنون والعلاقات القائمة بينها أمر مطروح منذ القدم ، ولعل زواج “زيوس” من ربة الذاكرة “منيموزينة” وأولادها ربات الفنون التسع جميعاً في (المثيولوجيا/الأساطير) الإغريقية له دلالته الواضحة في فكرة العلاقة بين الفنون ، حيث “تكونت تبعاً لهذا التراث الأسطوري لدى الأقدمين نظرية ونسق حول مثل هذا التفاعل المتبادل ، وبقيت هذه النظرية وهذا النسق في جوهرهما كما هما حتى عصر النهضة”(1). فالصلة أو العلاقة بين الفنون وبعضها البعض يوجد عليها شبه إجماع بين دارسي الفنون، وهذه العلاقة كما يرى الكثيرون ليست وليدة اليوم ، ولكنها متأصلة منذ بداية الحضارات الإنسانية ، كقدم الأنواع الفنية نفسها.
لقد عمل الروائيون على توظيف العديد من التقنيات داخل بنيات خطابهم الروائي ، وبالأخص لدى كُتَّاب الستينيات ومن تلاهم من الروائيين الذين ابتكروا أشكالًا روائية جديدة تتلاءم والظروف التي عاشها هذا الجيل من المبدعين ، ففي هذا المناخ الذي تتجاور فيه المتناقضات وتتضخم فيه الاسترابة ، يختفي الوضوح وينتشر الإبهام والغموض ويحتاج الكاتب إلى تطوير أدواته وتغيير أساليب تعبيره لاستيعاب هذه الحالة الجديدة ، وقد لجأ الكُتَّاب إلى فن السينما يستعيرون منه التقنيات التي تساعدهم في إنتاج هذه الأشكال الروائية الجديدة ، وكان بين أهم الأدوات التي استعارتها الرواية العربية من منجزات فن السينما تقنية المونتاج السينمائي .ويحاول المقال في السطور القادمة بيان تجليات إحدى تقنيات فن المونتاج (تقنية الازدواج) من خلال إحدى الروايات العربية المعاصرة (رواية ميرامار لنجيب محفوظ) .
الإشكالية:
والسؤال الملح الذي يفرض نفسه هو “لماذا نجيب محفوظ؟ ولماذا ميرامار؟ ”
فـ” نجيب محفوظ ” يحتل مكانًا فريدًا في تاريخ الرواية العربية، ولقد لعب دورًا مهمًا في تطورها لم يتح لكثيرين غيره من كتاب العالم، وترك” نجيب محفوظ ” للمكتبة العربية والعالمية زخمًا كثيرًا من أعماله الإبداعية.
ولقد رافقت مسيرة ” نجيب محفوظ ” السردية اتجاهات وأساليب سردية مختلفة وعبرت عن نفسها في أشكال عدة مؤكدة حضورها في المشهد السردي العربي والعالمي في آن معًا لكنها لم تنل من المشروع السردي المحفوظي ولم تنجح في ركنه على الرف أو دفعه إلى الظل، لخصائص امتاز بها، تكشف عنها الدراسة من خلال رواية “ميرامار” التي اختارها الباحث لتكون النموذج التطبيقي.
هذا من ناحية الإنتاج الأدبي، أما من ناحية علاقته بالسينما، فكما يقول النقاد المتخصصون في النقد السينمائي: “لا تقل أهمية وجود نجيب محفوظ في السينما عن أهمية وجوده في أدبنا المعاصر، بل لعل وجوده في السينما أكثر أهمية من وجوده في الأدب من عدة نواح، فالمسافة الثقافية التي تفصل بين نجيب محفوظ وغيره من العاملين في حقل السينما تفوق بقدر ملحوظ المسافة بينه وبين غيره من الأدباء، ومن ناحية أخرى فإن السينما تمنح ” نجيب محفوظ ” قدرة على التأثير أوسع انتشارًا مما يتيحه الأدب، ولن نجانب الحقيقة إذا زعمنا بأن انتشار ” نجيب محفوظ ” عن طريق السينما أرفع من انتشاره في مجال الأدب نفسه(2).
وقد كان هذا دافعًا قويًا إلى إقامة العديد من الدراسات التي تناولت العلاقة بين أدب نجيب محفوظ والفن السينمائي، ولقد وقع الباحث على عدد من هذه الدراسات بجانب أن هذه الدراسات قد أحالت الباحث إلى دراسات أخرى لم يطلع عليها الباحث تتحدث أيضًا عن علاقة نجيب محفوظ بالسينما.
ومن هذه الدراسات وأهمها كتاب “نجيب محفوظ على الشاشة” (1945م – 1988م)، لـ”هاشم النحاس” الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة الألف كتاب الثاني برقم (80) عام (1990م)، والذي تناول فيه الباحث دور نجيب محفوظ في السينما المصرية وبَيَّنَ فيه مدى كبر حجم العلاقة بين ” نجيب محفوظ ” والسينما وأرجعه إلى عدة أسباب هي:-
أولا: أن ” نجيب محفوظ ” يعد أول أديب يكتب للسينما، بدأ عام (1945م) ، وكان أول أفلامه “مغامرات عنترة وعبلة”، وبعده كتب سيناريو فيلم “المنتقم”.
ثانيًا: أن ” نجيب محفوظ ” يعد أكثر الأدباء المصريين أعمالًا في السينما.
ثالثًا: تحتل الأفلام التي كتب لها نجيب محفوظ السيناريو أو القصة التي أخذت من أعماله الأدبية مكانة خاصة في تاريخ السينما المصرية.
رابعًا: أن ” نجيب محفوظ ” هو الأديب الوحيد الذي ارتبطت وظيفته ارتباطًا مباشرًا بالسينما منذ عام (1959م) ، وحتى إحالته إلى المعاش سنة (1971م) ، حيث عمل مديرًا للرقابة ثم مديرًا لمؤسسة دعم السينما ورئيسًا لمجلس إدارتها، ثم رئيسًا لمؤسسة السينما، ثم مستشارًا لوزير الثقافة لشئون السينما.
وثاني هذه الدراسات هو كتاب “السينما في أدب نجيب محفوظ” للدكتور عبد التواب حماد والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة آفاق السينما (32) عام (2003م). والذي يهم الدراسة في هذا المقام هو الباب الثاني من القسم الأول من هذه الدراسة، وكذلك الباب الثالث وبالأخص الفصل الأول منه من القسم الثاني، وفي الباب الثاني والذي عنونه المؤلف بـ “المقومات السينمائية لأدب نجيب محفوظ” قدم الكاتب كل المقومات التى لمسها في أدب محفوظ.
بجانب هاتين الدراستين توجد رسالة أكاديمية بعنوان “تصوير شخصيات نجيب محفوظ في السينما” للباحثة “أميرة الجوهري” مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من معهد النقد الفني (1993م).
وبجانب ذلك توجد مجموعة من المؤلفات تهتم برصد العلاقة بين ” نجيب محفوظ ” والسينما، من هذه المؤلفات “نجيب محفوظ والسينما” لـ”سمير فريد” ، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام (1990م) ، وكذلك “أدباء مصر والسينما” والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام (1999م) للمؤلف نفسه ، بالإضافة إلى كتاب “السينما والأدب في مصر” لـ ” محمود قاسم ” ، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام (1999م) ، و”عالم نجيب محفوظ السينمائي لـ ” الدكتور وليد يوسف” ، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ، سلسة آفاق السينما (14) عام (2001م).
هذا بالنسبة للسؤال “لماذا نجيب محفوظ؟” أما “لماذا “ميرامار” بالذات دون غيرها من أعمال ” نجيب محفوظ ” ؟ فربما لأن رواية “ميرامار” تنتمي لجنس أدبي عنوانه “الرواية” ، وهي تختار مواصفات نوع روائي متكامل أكثر تجديدًا، وتسعى إلى التقاط مختلف التحديدات والتعريفات الجوهرية التي طُرحت بخصوص الجنس الروائي في مختلف عصوره بدءًا من “هيكل” ووصولًا إلى “كريماص” ونظريات “جورج لوكاتش” و”ميخائيل باختين” ، و” لوسيان جولدمان” في كتابه “دفاعًا عن علم اجتماع الرواية” وغيرهم ، مع ضرورة العلم بأن الدراسة التفصيلية لوحدات هذا النص السردي تستوجب الوقوف على حيوية عناصره، والنظر إلى صورته، واستجلاء نظام وحداته، وهي تتصل فيما بينها فتضيء جانبًا أساسيًا من شخصيته الأدبية، هذا الجانب الذي يرتبط بترتيب الوحدات ونظامها ، وهي تشكل إطارها الخاص بما تشتمله من مساحة سردية، وبما تقيمه من علاقات فيما بينها، لتكون بذلك لحمة النص ومجال الارتباط بين أجزائه، فهي تنتقل في شمول المعنى وامتداد عمله من الحدود الخارجية للنص
إلى طرائق ارتباط وحداته الداخلية وأوجه ترتيبها , ويمكن أن يوجز الباحث أسباب اختيار رواية “ميرامار” دون غيرها من الروايات في الأسباب الثلاثة التالية: –
أن رواية “ميرامار” تم تحويلها إلى فيلم(3) يحمل الاسم نفسه ، وتم تناول هذه العملية التحويلية كثير من الباحثين في عديد من الدراسات(4)، وذلك راجع إلى أن الرواية غنية بالخصائص السينمائية.
شهادة نجيب محفوظ نفسه عن مدى تأثره بالسينما في كتاباته الروائية، وذلك عن طريق سؤال وُجه إليه من مجلة الموقف الأدبي: “ما مدى تأثر أعمالك الروائية والقصصية بمزاولتك للمعالجة السينمائية وكتابة السيناريو؟ ألا ترى أن قصتك “فنجان شاي” نموذج واضح لتأثرك بالفن السينمائي؟.
الجواب: الحقيقة بعد ما عرفت أنواعًا من المسرح الحديث أعتبر قصة “فنجان شاي” نوعًا من المسرح التسجيلي قبل أن نتعرف عليه. إنما السينما تأثرت بها في أعمال كثيرة مثل استخدام الخيال البصري في الرواية، والخيال البصري هو أساس السينما ، وأعتقد أن ميرامار يظهر فيها التأثر بالخيال البصري لأني أعتمد في رواياتي على المنظر وليس على السرد”(5).
النص السردي لـ “ميرامار” يعيش سردية مستفزة تثير قلق القارئ، وترغمه على أن يعيش المعاناة كثيرًا لإعادة حياكة النسيج السردي، لذلك قامت عليها العديد من المقالات والدراسات النقدية حتى وصل الأمر أن تم وضع هذه الرواية في حقل الروايات المشكل(6).
وأحد هذه الإشكاليات مسألة التأثير والتأثر، وهي تبين أن ” نجيب محفوظ ” قد تأثر ببعض الأعمال الروائية العالمية منها بالتحديد “رباعية الإسكندرية” للورنس دريل، و”الصخب والعنف” لفوكنر، فتذكر إحدى الباحثات أنه ” منذ أن نشر الكاتب الإنجليزي لورنس دريل رباعية لإسكندرية(1957م – 1960م)، أصبح اسم الإسكندرية علمًا على مدينة غريبة تموج بأنماط عجيبة من البشر، لا يجد القارئ العربي بينها وجهًا واحدًا يعكس وجهه أو يتعاطف معه” وتواصل كلامها “بأن نجيب محفوظ يطلع علينا بروايته الجديدة في موعده من كل عام، فإذا هي رباعية رائعة للإسكندرية الحقيقية بواقعها الذي نعرفه ونعيش فيه، مدينة مصرية حقًا في الستينيات ولكن لها وجهًا خاصًا بها يمثله تاريخها الطويل”(7).
ثم يطل علينا باحث آخر يريد أن يثبت من خلال مقال له في مجلة فصول للنقد الأدبي ” أن كثيرًا من الروائيين العرب قد تأثروا في كتاباتهم الروائية برواية الكاتب الأمريكي “وليام فوكنر” (1897م – 1962م) “الصخب والعنف” وإثبات هذا التأثر من قبل الكتاب العرب من خلال أربع روايات وهي: “ما تبقى لكم” سنة 1966م لـ”غسان كنفاني” ، “ميرامار” 1967م لـ”نجيب محفوظ “، “دار السفينة” 1970م لـ”جبرا إبراهيم جبرا”، و”تحريك القلب” 1982م لـ”عبده جبير”.
والذي يهم الدراسة في هذه الروايات الأربع رواية “ميرامار” فكاتب المقال يذكر أن نجيب محفوظ قد تأثر برواية “الصخب والعنف” تأثرًا قويًا، لكنه كان أقل وضوحًا وأكثر دهاءً ؛ وذلك راجع إلى أن قدرة نجيب محفوظ الكبيرة على الاستيعاب والأخذ من “فوكنر” وتمثله أكبر بكثير من غيره من الكتاب الروائيين الثلاثة؛ لأنه استطاع أن يكسو ما نقله عنه بغلالة كثيفة من الأقنعة المحفوظية المتميزة إلى الدرجة التي تدفع البعض إلى القول بعدم وجود تأثير أدبي.
ثم يواصل الكاتب في عقد المقارنة بين “الصخب والعنف” و “ميرامار” يخرج منها بإثبات رأيه في تأثر نجيب محفوظ بـ” فوكنر” في هذا العمل” فمنذ البداية نلاحظ أن “ميرامار” مثلها في ذلك مثل “الصخب والعنف” رواية تهتم بجدلية العلاقة بين الماضي والحاضر بالطريقة التي يهبط بها الماضي والحاضر ويتفاعل معه…وكذلك يعتمد نجيب محفوظ كما فعل “فوكنر” على أسلوب المنولوج الداخلي في بناء الرواية، والذي أتاح لشخصياته الأساسية أن تروي كل منها الأحداث من وجهة نظرها…غير أن أوضح أشكال التأثر برواية فوكنر في “ميرامار” هو بناء الشخصيات ، ففي “ميرامار” نجد أننا إزاء سبع شخصيات: ثلاث منها تنتمي إلى الجيل المسن الكبير، وهي عامر وجدي وطلبة مرزوق وماريانا. وتقابل هذه الشخصيات الثلاث في “الصخب والعنف” شخصيات: الأب كومسون، والخال مري، والأم السيدة كومسبون. وأما الشخصيات الأربع الشابة: حسني علام، ومنصور باهي، وسرحان البحيري، وزهرة، فإنها تقابل الأخوة كومسون: بنجي وكوينتين وجاسون وكادي على الترتيب. هذا بالإضافة إلى أن مونولوجات الشبان الثلاثة تظهر في “ميرامار” بنفس ترتيب مونولوجات الأخوة الثلاثة في رواية “فوكنر”، وبعد هذه المقارنة التي عقدها كاتب المقال بتناول الشخصيات والأحداث بشيء من التفصيل حتى يتعرف القارئ على حقيقة العلاقة بين الروايتين، وعلى مدى دين “محفوظ” لرواية “فوكنر”(8).
وفي ظن الباحث أن كل ما سبق كان دليلًا واضحًا على أن رواية “ميرامار” من الروايات التي يجب أن تُصنَّف في فضاء الروايات ذات الطابع المشكل، وكل هذا كان سببًا في اختيار هذه الرواية من أعمال نجيب محفوظ .
وبالدخول إلى عالم “ميرامار” فإن الباحث يرى أنه لا يمكن له ولا لأي باحث يريد أن يتصدى لدراسة هذه الرواية، وما على شاكلتها الفنية، دون التعرض لما اصطلح عليه من قبل النقاد الأنجلو أمريكيين “وجهة النظر Point of view” أو فيما عرف بعد ذلك – بعدما توالت المصطلحات النقدية البديلة لمصطلح “وجهة النظر Point of view” – من قبل نقاد السرد، ونتج عن ذلك زخم المصطلحات كبدائل لوجهة النظر من أمثال: –
وجهة النظر Point of view / View point ، السارد narrator ، الـرؤيـة view / Vision aspect، المنـظور Perspective ، بـؤرة السـرد Focus of narration، الموقع Position ، التحفيز Motivation، التبئير Focalization، الرؤية السردية Narrative vision، زاوية الرؤية القولية / الخطابية Discoursal point of view …. إلى غير ذلك من المصطلحات المعنية بوجهة النظر(9).
تعود هذه الكثرة من المصطلحات وتعددها إلى “سيولة تقنيات السرد الروائي من ناحية، وبسبب القياسات الجزئية من ناحية أخرى، حتى إن بعض النقاد أطلق مصطلحه وعينه على نموذج روائي بعينه مما جعل الاستقراء ناقصًا (10).
بالإضافة إلى أن هذا الزخم من المصطلحات نابع أيضًا من العلاقة الوطيدة بين الفن الروائي، والفنون الأخرى (11)، -وهذا هو صميم منطلق البحث – والذي حاول أن يؤكده كثير من الباحثين وهو ما حرصت على إظهاره الدكتورة “سيزا قاسم” بقولها إن”مصطلح المنظور مستمد من الفنون التشكيلية وبخاصة الرسم؛ إذ يتوقف شكل أي جسم تقع عليه العين والصورة التي تتلقاه بها على الوضع الذي ينظر منه الرائي إليه” (12)، ويوضح باحث آخر بقوله” إن هذا المصطلح شكله ومحتواه مستعار من الفنون التشكيلية، ففي مجال الرسم والنحت مثلا تختلف الأشكال المرسومة أو المجسمة تبعًا لاختلاف ثقافة الفنان وفكره… وفي مجال التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي تختلف الصورة الملتقطة لإحدى المنشآت عن صورة أخرى للمنشأة نفسها عندما تكون ملتقطة من زاوية أخرى، وقد كان الوعي النظري بهذه التقنية أسبق في النقد الخاص بالتصوير والرسم والسينما منه في النقد الأدبي” (13) .
ووجهة النظر – بدون الخوض في فوضي التفصيلات- هي القناة المعرفية التي تقودنا نحو البؤرة المتوخى أن تكون نقطة يجب على القارئ النظر إليها، وهي المنظور الذي يقدم السارد الأحداث التي يحكيها والشخصيات المساهمة فيها، ومن ثم فإن “أساليب السرد تتعدد بمقدار تعدد الرؤى أو زوايا النظر أو البؤر السردية أو المنظورات، وهكذا تبرز ضرورة الوقوف عند الرؤية بوصفها وجهة النظر البصرية والفكرية والجمالية التي تقدم إلى المتلقي عالمًا فنيًا بتكوينه أو نقله عن رؤية أخرى” (14).
وهذه الرؤية لا تنفصل عن عنصر آخر من عناصر السرد، وترتبط ارتباطًا وثيقًا به فكلاهما وجهان لعملة واحدة وهو الراوي ، فمن هو الراوي؟ إنه “هو الشخص الذي يروي الكلام” (15) , أو هو من يقوم بدور إيصال المادة السردية وتفصيلاتها في الرواية إلى المتلقي.
على أن التأثيرات القوية التي تركتها السينما في أساليب الرواية “عملت على تغيير صورة الراوي بكل أشكاله السابقة، بل عملت في كثير من الأحيان على اختفائه تمامًا من ساحة الأحداث، أو التخلص منه، وعملت في أحيان أخرى على امتزاجه بالسارد، بل إن السارد نفسه قد اختفى في الروايات التي يطلق عليها أصحابها اسم الروايات الجديدة، أو روايات الأشياء، وأصبحت الرواية بفعل التأثيرات السينمائية مجموعة من الأشكال المشيدة، سواء على مستوى التعبير أو على مستوى الحكاية ” (16).
فنجيب محفوظ ” يمارس في روايته “ميرامار” لعبة السرد باتجاه ديمقراطية التعبير، فهناك رواة متعددون يمارس كل واحد منهم حيزًا مستقلًا من المساحة الكلامية”(17).
ففي “ميرامار” يتكامل المرئي من الزوايا المتعددة بتعدد الرواة “شأنها في ذلك شأن اللوحة التشكيلية التي تتقاطع الخطوط والألوان فيها لتتكامل معبرة عن تقاطع الرؤى، وهي تنظر إلى ما تنظر إليه، من زواياها العدة” (18).
فمن خلال دراسة تقنية وجهة النظر المبنية عليها الرواية تستطيع الدراسة أن تستنتج هذا الازدواج من خلال وجهات نظر الشخصيات الأربع التي قامت عليها الرواية.
إن “عامر وجدي” الذي يبدأ الرواية وينهيها، فهو يشكل سرده بأسلوب يراوح بين الماضي والحاضر ويمازج بين ذكرياته النضالية البعيدة وأحداث البؤرة الروائية الراهنة، وهو أمر لم يتح لباقي الرواة. أما “حسني علام” فإن المؤلف يعامله معاملة خاصة، فأسلوب “حسني علام” أسلوب شعري متميز قائم على التداعيات المكثفة رغم أن الأسلوب يتناقض مع أميته فهو الشاب الذي يمتلك المائة فدان تواجه خطر الاستيلاء عليها من قبل الإصلاح الزراعي. لا يمتلك من الهوايات سوى هواية قنص النساء، ومطاردتهن ومحاولة الاعتداء عليهن أحيانًا كما فعل مع “زهرة”.
وفي فصل “حسني علام” تتضح بنية الرواية المعتمدة على حسم الأحداث الرئيسة، فالعلاقة مع “زهرة” والهجوم عليها، وصراع زهرة مع خيانة “سرحان البحيري” لها وشجارها معه، والسهرة مع أم كلثوم، ثم موت سرحان البحيري وهي كلها أحداث مركزية في جسم الرواية، يجد المطالع للرواية فيها ردودًا مختلفة من كل شخص عليها.
وإذا أراد الباحث أن يقدم قراءة نقدية تحليلية لهذا العمل المحفوظي محاولًا استنطاق تقنية الازدواج ودلالتها داخل بنيات العمل الروائي فإن أول ما يقابل الباحث في هذا العمل هو العنوان فـ”ميرامار”- كما يوضح أحد الباحثين – هي كلمة من أصل لاتيني ولكنها حاضرة اليوم في اللغة الأسبانية، وتتركب هذه الكلمة من مقطعين هما الفعل “ميرا” ويعني يشاهد بإعجاب، ومن الاسم “مار” ويعني البحر، ومعنى الكلمة أيضًا ينسحب على بعض المفردات مثل: المسكن، والفندق الجميل، والمكان الجميل القائم على الشاطئ (19).
فالعنوان مشحون بدلالات عميقة تجسدت في لفظة واحدة تحتمل أن تكون اسم علم لعاقل أو لغير العاقل، والعنوان “ميرامار” يسهم في برمجة القراءة والتأويل عند القارئ فهو يحبس النص ويحدد أشكاله ومضامينه(20).
فـ”ميرامار” بالإضافة إلى أنه عنوان العمل الفني فإنه أيضًا الإطار الذي تدور فيه أحداث الرواية، فله أهمية كبيرة في كونه عنصرًا فاعلًا في تطور بناء العمل وفي تحديد طبيعة الشخوص وتأكيد العلائق بينهم.
إنه بنسيون اختارته الشخصيات وهو أكثر استقرارية من الفندق، عدد حجراته محدود يقطنه عدد محدود من النزلاء ويديره شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص والإقامة فيه أطول نسبيًا ولكنها تبقى دائمًا مؤقتة.
يمثل بنسيون “ميرامار” عند “نجيب محفوظ” حلمًا هروبيًا فهو ليس مكانًا متسعًا لكنه مختار بعناية ودقة، وتهيئته جزء من بناء الشخصية في رواية “ميرامار”، فالكاتب لم يلجأ إلى المكان المتسع حتى لا يضيع الإنسان ويصبح بلا هوية ويتلاشي كيانه، وحتى لا تنفلت الشخصية والمكان من حيز الرؤية والوصف المتقن إلى حيز التعتيم عند الروائي، وهذه حالة مستقرة أو قارة كما يطلق عليها الشكلانيون إذ يجتمع كل الأبطال في نفس المكان كما في “ميرامار” وهو مكان يتيح إمكانية لقاءات غير متوقعة ولكنها كثيرة الورود.
المكان هنا عام ليس ملكًا لأحد وبالتالي ليس لأحد الهيمنة فيه على الآخر، كل الشخصيات فيه لها نفس الامتياز المكاني نفسه، وهو مثل خشبة المسرح التي يصعد فوقها الجميع لأداء أدوارهم كبر هذا الدور أو صغر، فهو يجذب خطى الهاربين، أو المنفيين من أماكن أخرى (القاهرة أو طنطا) بحرياتهم أو رغمًا عنهم، فهذا “عامر وجدي” يهجر القاهرة بعد أن فقد عمله ودوره في الكفاح، و”طلبة مرزوق” يهجر القاهرة التي شعر بهوانه فيها، والريف الذي لم يعد له مكان فيه بعد أن فقدت طبقته امتيازاتها ودورها، و “منصور باهي” يطرده أخوه من القاهرة حتى يبعده عن تنظيمه، و”زهرة” هاربة من القرية التي فقدت فيها قدرتها على الاختيار، إن كل الشخصيات بما فيها “سرحان البحيري” و “حسني علام” فقدت مكانها الأليف “البيت” واختارت البنسيون لكونه المكان المحايد للجميع فغدوا جميعًا أسرى له.
بالإضافة إلى ما سبق من دلالات “ميرامار” فإن هناك علاقة وطيدة بين المكان والشخصية مما يجعله يمثل أهمية كبرى داخل بنيان العمل الروائي، ويدفع الباحث إلى التأكيد على أنه شخصية اعتبارية، فلا “ميرامار” بدون “ماريانا” فالمكان وحده لم يعد مكان جذب لشخصيات الرواية، “فعامر وجدي” و “طلبة مرزوق” لا ينشدان “ميرامار” فقط بدون “ماريانا”، يضاف إليهما “منصور باهي” ؛ إذ جاء بتوصية من أخيه إلى “ماريانا” ، و الشيء نفسه بالنسبة لـ “منصور” و”سرحان” فهما ينجذبان إلى “ميرامار” من أجل “زهرة”، وهذه تجعل العلاقة هي التي من المكان “ميرامار” ركنا مهمًا من أركان البناء الروائي عند نجيب محفوظ؛ فهو يَشُد بصر القارئ وأفكاره في بقعة محددة هي بؤرة الحدث، فلا تشتت ولا ضياع بين مساحات أخرى وفراغات محدودة غير مجدية فنيًا، فالمكان محدود وثابت والشخصيات تغذيه وتؤثر فيه، وتجعل الرواية متعلقة بجوهر الإنسان والمراحل التي تمر بها البشرية.
ويرى الباحث ضرورة أن يتم إظهار تقنية الازدواج من خلال تداعيات سرد الشخصيات وخطابها الروائي و بالترتيب نفسه الذي جاء في الرواية، فنتتبع كل شخصية من شخصيات العمل بدءًا من “عامر وجدي” وانتهاءً بـ”سرحان البحيري”.
فالقارئ يتلقى الحدث في “ميرامار” من وعي ” أربع شخصيات هي على التوالي: “عامر وجدي” ، “حسني علام”، “منصور باهي”، “سرحان البحيري” ، غير أن الحدث في مجموعه يبدأ وينتهي من وعي “عامر وجدي” ربما لأن هذا الوعي هو القادر على أن يمنحنا الخلفية المتكاملة المدعمة للحدث، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الميتافيزيقي، وتقوم بجانب رؤية “عامر وجدي” وجهة نظر كل من “حسني علام” و”سرحان البحيري” ، و”منصور باهي” ، الذي يمثل كل منهم امتداد لعامر وجدي في اتجاه مختلف”(21).
( للبحث صلة)
الهوامش :
- العلاقة المنهجية بين الأدب والفنون الأخرى : يوزف شتريلكا ، ترجمة : مصطفى ماهر ، مجلة فصول ، القاهرة ، العدد 11 (يناير- فبراير- مارس، 1985م) ص20.
- نجيب محفوظ على الشاشة ( 1945 – 1988 ): هاشم النحاس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط2 ،1990م، ص15.
- ( فيلم ميرامار) إخراج: كمال الشيخ، سيناريو وحوار: ممدوح الليثي، تصوير وحيد فريد، إنتاج: مؤسسة السينما، وعرض لأول مرة في 13 أكتوبر 1969، حيث قام بدور عامر وجدي (عماد حمدي) وبدور طلبة مرزوق (يوسف وهبي) وبدور حسني علام (أبو بكر عزت) وبدور منصور باهر (عبد الرحمن علي) وبدور سرحان البحيري (يوسف شعبان) وبدور زهرة (شادية) ومحمود أبو العباس (عبد المنعم إبراهيم).
- للمزيد انظر: نجيب محفوظ على الشاشة (1945 – 1988م) لهاشم النحاس، ص202 – 240، السينما في أدب نجيب محفوظ: عبد التواب حماد، ص175: 197، جماليات الفيلم السياسي المصري: شكري حسن الشامي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة آفاق السينما، رقم 51، القاهرة 2007، ص103: 115.
- أتحدث إليكم: نجيب محفوظ، مجموعة حوارات، دار العودة، بيروت، 1977، ص36.
- من هذه الدراسات على سبيل المثال انظر: في الرواية العربية المعاصرة، فاطمة موسى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1، ط2، القاهرة1977م، ص13- ودراسات في الرواية العربية: أنجيل بطرس سمعان، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة 1987م، ص143- الشكل الفني في الرواية المصرية من عام 1965 حتى عام 1995: محمود محمد عيسي، مكتبة نانسي دمياط، سنة 2004م- الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ: سليمان الشطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2004م، ص355- “الراوي…. الموقع والشكل”تعدد المواقع في ميرامار: يمني العيد، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت1986م- في الرواية العربية بين الخصوصية وتميز الخطاب “لعبة البدائل”:يمني العيد، دار الآداب البيروتيه،بيروت 1998م، ص167- قراءة في الرواية نماذج من نجيب محفوظ: محمود الربيعي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1989م، ص127- قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ دراسة تحليلية لأصولها الفكرية والجمالية : نبيل راغب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1975م، ص331 -الرمزية في أدب نجيب محفوظ : فاطمة الزهراء محمد سعيد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1981م، ص258- اتجاهات الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1967م : شفيع السيد، مكتبة الشباب، القاهرة 1967م، ص309- تأملات في عالم نجيب محفوظ : محمود أمين العالم،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة1970م ، ص131- الشكل الروائي من “اللص والكلاب” إلى “ميرامار” : لطيفة الزيات، مجلة “الهلال”، فبراير 1970م- نجيب محفوظ : مصادر تجربته الإبداعية ومقوماتها : صبري حافظ، مجلة الآداب، العدد السابع، يونيو 1983م، وكذلك تناظر التجارب الحضارية وتفاعل الرؤى الإبداعية دراسة في تأثير الصحف والعنف على الرواية العربية : صبري حافظ، مجلة فصول ،القاهرة ، المجلد الثاني العدد الثالث 1983م، وله أيضا تراجيديا السقوط والضياع، مجلة المجلة، يونيو 1967م- ميرامار : بداية المرحلة الرابعة : محمد حسن عبد الله، مجلة البيان، العدد 39 سنة 1969م.
- في الرواية العربية المعاصرة: فاطمة موسى ، ص13: 14.
- انظر تناظر التجارب الحضارية وتفاعل الرؤى الإبداعية، دراسة في تأثير “الصخب والعنف على الرواية العربية” : صبري حافظ، مجلة فصول ،القاهرة ، المجلد الثاني العدد الثالث 1983م ،ص224 وما بعدها.
- للمزيد حول “وجهة النظر Point of view” يمكن الرجوع إلى: بناء الرواية: سيزا قاسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2004م ، ص181 وما بعدها- خطاب الحكاية: جيرار جنيت ، ترجمة محمد معتصم وآخرون، المشروع القومي للترجمة، ط2، القاهرة1997م ،ص 197-عودة إلى خطاب الحكاية: جيرار جينيت، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، ، ط1، الدار البيضاء 2000م، ص83- المتخيل السردي:عبد الله إبراهيم،المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء1990م، ص61، 115- وجهة النظر في روايات الأصوات العربية: محمد نجيب التلاوي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2000م- الفن الروائي: ديفيد لودج، ترجمة: ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة ضمن المشروع القومي للترجمة، ط1،القاهرة 2002م، ص31- بنية النص السردي: حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي، ط2= =الدار البيضاء2000م، ص46- دراسات في الرواية العربية، أنجيل بطرس سمعان، ص90 وما بعدها- وجهة النظر في الرواية على مستوى المكان والزمان: يوريس أوسبنسكي، ترجمة : سعيد الغانمي، مجلة فصول، المجلد الخامس عشر العدد الرابع، شتاء 1997م، القاهرة، ص256- تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، ط4 الدار البيضاء2005م، ص283- نظرية الرواية: السيد إبراهيم، دار قباء، القاهرة 1998م، ص144-الراوي والنص القصصي: عبد الرحيم الكردي، مكتبة الآداب، القاهرة، 2006م.
- وجهة النظر في روايات الأصوات العربية: محمد نجيب التلاوي، ص13.
- للمزيد يمكن الرجوع إلى:- أساليب السرد في الرواية العربية: صلاح فضل، دار سعاد الصباح، ط1، الكويت 1992، ص8 – القصة والفنون الجميلة: السعيد الورقي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الشباب، القاهرة 1997م ، ص21، 50، 54، السرد في الرواية المعاصرة: عبد الرحيم الكردي، مكتبة الآداب، ص152 وما بعدها- بناء الرواية: سيزا قاسم، ص181- فن المونتاج السينمائي : كارل رايس ، ترجمة : احمد الحضري ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، الطبعة الثانية عشر ، القاهرة 1964م، ص52.
- بناء الرواية: سيزا قاسم، ص181.
- السرد في الرواية المعاصرة: عبد الرحيم الكردي، ص152.
- المتخيل السردي: عبد الله إبراهيم، ص116.
- Literary term and criticism, John Peak and Martin Coyle, London 1985,see “narrative”..
- السرد في الرواية المعاصرة: عبد الرحيم الكردي ، ص130.
- الراوي… الموقع والشكل، تعدد المواقع في ميرامار: يمني العيد، ص118.
- إشكالية الراوي: ياسين فاعور، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، العدد 306، تشرين الأول 1996.
- ميرامار… البنسيون والرواية، شوقي يوسف، مجلة أمواج، العدد الثالث عشر ، مصر 2002م.
- قراءة في ذاكرة السرد المصري : بشرى تاكفراكست ، المغرب ، ص 7 .
- الشكل الروائي من “اللص والكلاب” إلى “ميرامار”: لطيفة الزيات، مجلة الهلال، القاهرة، فبراير 1970.

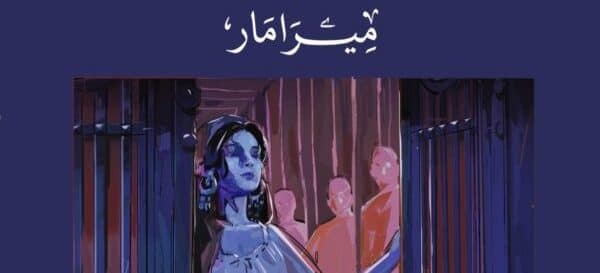


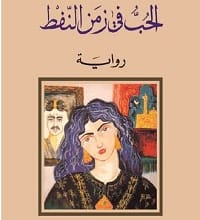
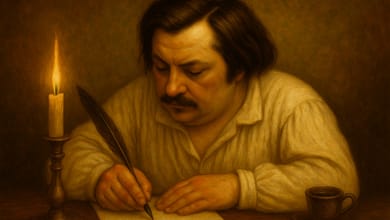
المبدع الدكتور إبراهيم موفق باذن الله دائما