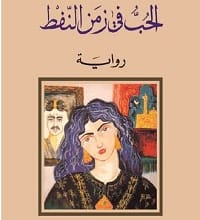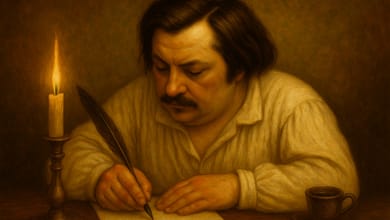كتب عبد الستار الجامعي
تمهيد:
إنّ الناظر في متن ديوان صدر ديوانٌ بعنوان “مناجاة“(1) للشاعر التونسي الحبيب العوّادي يجده هجرة صوفيّة من الشاعر نحو ربّه. فكيف صوّر الشاعر هجرته الروحية هذه؟ وكيف تجلّى نظامُ الخطاب الشّعري، اللغوي والدّلالي، في مناجاة؟ وإذا ما اعتبرنا، أن “لا تحقّق لأي عمليّة تخطابية دون لجوء المتكلّم إلى مسالك يحاول بها تحقيق غايته أو إيصال مقصوده إلى مخاطبه“(3)، فهل يجوز لنا حالئذ أن نتساءل عن هذه المسالك التخاطبية التي سلكها الشاعرُ في رحاب خطابه الشعري؟ وعن الدلالات والقصود؛ البيّنة والمُضمرة التي أراد تبليغها من وراء الخطاب؟
1. شعريّة الخطاب الصّوفي في ديوان “مناجاة”:
أحدث الشاعرُ الحبيب العوّادي بهذا الديوان شرخًا في أفق كتاباته الشعريّة. ويمكن أن نعتبر ديوانه هذا منعرجًا في تجربته الشّعريّة. فبعد ديوان “قال لي السندباد، تونس 2005” و”بلقيس في الوادي الكبير، تونس 2006 “وعَلَىَ أسْوار بغداد، تونس 2008″، وظلال وأضواء، تونس 2013″، ها هو الشّاعر نفسه يطلّ علينا إطلالةً جديدةً ومغايرةً لما ألفناه في دواوينه السّابقة. فمناجاةُ، كما يظهر في محيط الديوان، قصيدةٌ تنتمي إلى الشعر الصوفيّ جنسًا، بالرغم من الناظر في متن القصيدة، بعد ذلك، يلحظ أن هذه المناجاة يمتزج فيها الشعر الروحي الذي يتحدّث عن الله في ذاته، بالشعر الصوفي ذي البُعْد الأخلاقي التعبّدي. في خطابه يظهر الشاعرُ، في حساسيّة مرهفة، محاورًا ربّه وفق مسار تخاطبي أفقيّ، ووِفْق استراتيجيّة مخصوصة وضمن مسلك بيانيّ أساسه الكشفُ والصراحةُ والدقّةُ والاعترافُ ومناسبة المقام التخاطبي، أملاً في الخلاص والنجاة. وهو ما ينعكس في خطابه الآتي. يقول:
رَبَّــــاهُ
هَزَّنِي الشّوقُ إلَيكْ،
وَتَرَاءَتْ لِيَ
سُبُلُ الهُدَى
بَهْجَةً في نَاظِرَيْكْ(4).
والمتمعّنُ في متن الديوان يجد صاحبه مسكونًا بهاجس الرحلة. هي رحلةٌ روحيّة مُتخيّلة- وللصوفيّة نزوع واضح للسّفر، والرّحلة إلى ذلك مقوّم أساسيٌّ وبنيةً ثابتةً وأصيلةً في الخطاب الصّوفي- غنيّةٌ بأخبارٍ وتجاربَ وعقباتٍ عدّة اجتازها سالكُ الطريق، أي المُريد، في سبيل العودة نحو الحقّ والمسار الصحيح، نحو القُطب، أي الله، وقبل حلول الغروب وفوات الأوان:
رَبَّــــاهُ
الآنَ قَدْ عُدْتُ
قبْلَ المَغِيبْ،
وَقَبْلَ تَسَاقُطِ
ثُلُوج المَوْتِ في الأُفُقِ الرَّحِيبْ”(5).
ويُضيف:
هَا أَنَا عُدْتُ إليْكْ
قَبْلَ أَنْ تَلْتَفَّ السّاقُ بالسّاقْ،
وَكَانَ إليْكَ
“يَوْمَئِذٍ المَسَاقْ”(6).
وهي رحلةٌ مركّبة بأتمّ معنى الكلمة، يتخلّلُ طريقَها القلقُ والمعاناةُ والاضطرابُ والشدّةُ والانتظارُ. وقد قام بها الشاعر بجرأة واضحةٍ لأنّها مرتبطة بواقعه المعيشي. ونقلها جميعها وسلك فيها مسالكَ تخاطبيّة مخصوصة، على غرار المسالك التأليفيّة النمطيّة الممثّلة في الوصف. وقد كشف من خلالها الشاعرُ عن حالته من خلال أمارات وقرائن حاليّة بادية على جسده لا تتأتّى – على حدّ عبارة السّراج الطوسي- إلاّ “إذا انقطعت الأسبابُ، وخلُص الذكرُ، وصحا القلبُ ورقّ وصفا، ونجعت فيه الموعظةُ والذكرُ، وحلّ من المناجاة في محلّ قريب، وخوطب وسمُع الخطاب بأذن واعية، وقلب شاهد وسرّ طاهر، فشاهد ما كان منه خاليا“(7). يقول الشاعرُ، متوجّها إلى خالقه بالخطاب، سالكًا من أجل تبليغ مراده، مسالك طلبيّةً تضرّعيّة متمثّلة في الدّعاء، وأخرى استرحاميّة ممثّلة في الاستعطاف الممزوج بالخوف والرّجاء :
رَبَّــــاهُ
أَشْفِق
عَلَى مَنْ أتَاكَ
سَاجِدًا مُتَخَشِّعًا
جَاثمًا مُتَألِّمًا،
يَبْكِي مَصِيرًا،
أَسْوَدَ قاتِمًا(8).
فسيّان عنده، إذا ما وصل عند باب الرحمان، إن فُتح هذا البابُ أم ظلّ مغلقًا كما يقول. فمثله لا يخسر شيئا، وبالتالي لا يُخيفه انغلاق الباب، ولا ظلمة اللّيل، لأنّ كلّ ذلك لن يحول بينه وبين محبوبه:
ربّـــاهُ
مَدَدْتُ يَدَيَّ
فِيِ ظُلَمِ الدُّجَىَ،
شَوْقًا إِليْكَ
أو سَعْيًا إليْكْ،
فَإنْ قَبِلْتَ
فَذَاكَ شَأْنُكَ أَبَدًا
وَإِنْ أَبَيْتَ
بقيتُ أمَامَ البَابِ،
أرْقُبُ عَفْوَكَ(9).
والشّاعرُ بهذه الشدّة والحزم مع نفسه، غير عابئ بجمرة الانتظار، لا ولا هيّاب إزاء الوحل المحيط به، أو المحن التي حلّت به. إنّ المشاق والأهوال تهون كلّها أمام ملاقاة الرحمان، وكسب رضاه. لذلك ليس مستغربًا أن يظلّ طول العمر يطرق أبواب الرّجاء. وفي هذا هو يسلكُ المسلك الطلبي التضرّعي ويُقرّر:
ربّــــاهُ
سَأنتظرُ
مَا بَقِيَ
مِنَ العُمُرِ انْتِظارُ،
وَسَأَهْفُو
إلى الحُسْنِ المُقدّس دائِمًا(10).
إنّ هذه العذابات التي يصوّرها االشاعر والتي تتفاعل وتتبادل المواقع في طريق هذه الرحلة، وفي رحاب الخطاب، هي أساسيّة ولا غنى عنها بالنسبة إلى الشاعر الصّوفي. بل إنّها تُصبح لديه هيّنة في سبيل وصوله إلى اللاّ متاح، فيجعله مُتاحًا. وقد كشف عنها بجرأة مميّزة، وسلك فيها مسالكَ تخاطبيّة متعدّدة من أجل الوصول إلى غاياته التخاطبيّة، لاسيما في وقتٍ أصبح من النادر أن تعترف فيه النفسُ البشريّةُ بخيباتها وأخطائها. وهي كثيرا ما تعتقد أنّها بلا أخطاء، خصوصًا أنّ الفترة الزمنية التي ترتبط بمرحلة الكتابة الصّوفية هي عادة ما تُمثّل – أو كثيرا ما تكون- تتويجًا لمرحلة الصّوفي العُمريّة، التي تتطلب نبذًا للدّنيا وما يرتبط بها من دناءة ووضاعة، واغترابًا عنها، وتُسْهم إسهامًا كبيرًا في عمليّة الكتابة. فالشاعرُ، والمبدعُ بشكل عامّ، لا يعيش بمعزل عن محيطه: عن عائلته وعن أصدقائه وعن قُرّائه، ولا يمكنه ذلك وإلاّ حَكَم على نفسه بالانحلال والذوبان. هو مُطالبٌ بأن يحافظ على صورته اللاّمعة التي ارتسمت، من خلال كتاباته، في أذهان جمهوره، مثلما أنّه مُطالب بالمحافظة على أنموذج كتاباته الذي يُحقّق لهم مُتعة القراءة. هذا ما يجعل من مرحلة الاعتراف بالخطأ، أو مرحلة “وعي الوضع“(11)، والذنْب المقترفيْن، الذيْن هما وسيلة من وسائل تحقيق التوّبة: التّوبة من قرارات خاطئة أومن صَحْبَة سّيئةٍ ظلّ الشاعرُ أسيرًا لها، ويُسمّيها أعداءً، يقول:
الآنَ
خَلَصْتُ مِنْ دَائِي
وَأَعْدَائِي، (12).
والتّوبة من نفسه كذلك، و”إنّ النفس لأمّارة بالسّوء(13)، والتّوبة من الانتماء إلى العالم البشري موطن الضّعف والتّكالب والرّجس والزّوال، فليس غرامُ الشّاعر بالأماكن والتّرب، إنّما غرامه بالبُريق ولَمْحه على حد قول ابن العربي(14):
رَأَىَ البَرْقَ شَرْقيًّا فَحَنَّ إلَى الشَّرْقِ *** وَلَوْ لاَحَ غَرْبِيًّا لحَنَّ إلى الغَرْبِ
فَإِنَّ غَرَامِـــــي بِالبُرَيْــقِ وَلَمْحهِ *** ولَيْسَ غرامي بالأَمَاكِنِ والتُّرْبِ
هذا كلُّه، إذن، يجعل من رحلة الشاعر أشبه بالعمليّة الكزّة التي تتطلّب قدرًا من الجرأة ليس قليلا ولا هيّنًا. وهي إلى ذلك عمليّة تكلميّة تنبني على مسالك خطابيّة متعددّة: بنائيّة، طلبية، بيانية..إلخ. فهي تُنتزع مِنه انتزاعًا. ولكنّ الصّوفيَ المريد مُطالبٌ بذلك، وبأكثر. لأنّ التّوبة أُولى محطّات الطريق السّبع قبل وصول الشاعر إلى محبوبه، أيْ إلى الله. معلومٌ بأنّ هذه المراحل السبع هي، كما وردت عند السراج الطوسي: التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكّل، الرضى(15). وهو مُطالبٌ بالانفصال من أجل الاتّصال، وبتجاوز كلّ هذه الجزئيات والتحرّر منها من أجل بلوغ المعرفة الكاملة، التي هي “وسيلةٌ إلى الوصول بالإنسان إلى مرتبة الولاية” على حدّ عبارة الناقد المغربي “محمد مفتاح(16)، ومن أجل بلوغ الكمال المُطلق. فالكمالُ المطلق يبدأ بنفي الجزئيات والتفاصيل. وحقيقة الله ووَحْدانيته، تبدأ بتجاوز الحقائق الأخرى ونفيها. هذه التّوبة التي يعترف بها الصّوفي وبها يبدأ رحلته هي خطوة أولى وأساسيّة ولا غنى عنها لكسب رضا الله، والشاعر على وعي بها. لذلك نجده يوردها في صيغة التعجّب والإعجاب بدْءًا:
حَنَانَيْكَ
رَبَّاهُ حَنَانَيْكَ
حَنَانَيْكَ
مَا أجْمَلَ التّوْبَ إليْكْ !!(17).
ولكنّه قد صار متأكدّا، بعدئذ، من توبته هذه وواثقًا مطمئنّا. وهو ما وصل به حدّ اليقين. لذلك هو يوردها في صيغة الماضي، ويُلحقها بأداة التقرير “قد” فيجعلها في صيغة التوكيد، ويقرّ بتوبته ويقول بطمأنينة الواثق:
حَنَانَيْكَ
اللّهُمّ حَنَانَيْكَ
حَنَانَيْكَ
قد تُبْتُ إليك(18).
إنّ ميزة هذا الديوان، وميزة الشّعر الصوفي عمومًا، أنّ الشّاعر لا يرتبط فيه بمتلقٍّ خارجي، أيْ القارئ الخارجيّ الفعليّ الذي يتلقّف النصّ بُعيد نشره. فهذا القارئ يتراجع دوره في هذا الضرب من الخطاب، ويُتنحّى جانبا ويتوارى فيه، لكن إلى حين، فاسحًا المجال لمتلقّ آخر نموذجي: هو الله سبحانه وتعالى. إذْ به يهتمّ الشاعرُ، والصّوفي عموما، وإليه يروم توصيل خطابه وتبليغه وإليه يسلك مسالك متعدّدة. هي رحلةٌ سلك فيها الشّاعرُ طريقَ العشق الرّوحي الصّاعد مِنَ العبد نحو ربّه. وهو عشقٌ بريءٌ من الغرض ومُنزّه عن المنفعة والمُتعة، قوامه الوجد في أسمى تجلّياته التي يتعالى فيها عن العشق الإنساني، والاشتياق والحنين الرّوحي والتذلّل، ذلك أنّ “الأعزّاء إذا اشتاقوا أذلاّء”. وقد قيل لأعرابيّة: ما الحبُّ؟ قالت: جلّ عن أن يُسمّى، ودقّ عن أن يوصف، فهو كامنٌ كمون النار في الحجر، إن قَدَحْتُه أوْرى وإن تَرَكتُه توارى“(19). وفي السياق نفسه، يقول الشاعرُ سالكًا، كعادته في الخطاب، مسلكًا طلبيّا تضرّعيّا مُمثّلاً في الدّعاء، الذي نجده مبذورًا بشكل كثيف في “مُناجاة”، ويحتلّ فيها رُكْنًا ركينًا:
رَبَّـــاهُ
لا تُوصِدْ الأبْوابَ في وَجْهِ عَاشِقٍ
مُجْتَابٍ(20).
ويضيف:
ربّــــاهُ،
مَدَدْتُ يَدَيَّ
فِي ظُلَمِ الدُّجَى
شَوْقًا إلَيْكَ،
أَوْ سَعْيًا إِلَيْكْ(21).
ويُضيف:
وَالآنَ وَقَدْ رَأَيْتُ
اشْتَقْتُ إلَيْكْ(22).
والملاحظ أنّ مقاطع قصيدة “مناجاة”، وهي مائة وخمسون مقطعًا، تخضع لبنية واحدة مكرّرة، طلبيّة في الغالب، تُمثّل مفتاح “المناجاة”. إذ أنّها تُفتتح جميعها بالدّعاء الوارد بصفة مكرّرة في صيغة “ربّاه” خاصّة، والنّداء “يا وهّاب(ص،9)،”يا حيّ يا منّان“(ص، 17)، “يا ربّ الأرباب“(22)…ينبغي ألاّ يغيب عن محلّل الخطاب بهذا الصدد – وعلى أي محلّل في الخطاب- أنّ لهذا الأسلوب البلاغيّ، المُمثّل في التكرار، وظائفَ إيقاعيّة وخطابية متعدّدة، أقلّها: الإفهامُ والإفصاحُ والكشفُ وتوكيدُ الكلام والتشييدُ من أمره، وتقريرُ المعنى وإثباتُه (23). فالشاعر بالتالي قد توسلّ بهذا الأسلوب البلاغي، الذي تغصّ به “مناجاة”، رغبة منه في إنجاز فعلٍ مخصوص. لأنّ “التكلّمُ بشيء ما هو فعله وإنجازه” على حدّ عبارة فيلسوف اللغة ج. أوستين”(24). هذا الفعل المخصوص الذ يروم إنجازه فعل الإقناع: إقناع المتلقّي، وبالتالي إشراكه في الخطاب ودعوته إلى التفاعل معه وتبادل الأدوار. فيرضى عنه هذا الأخيرُ، ويرضى الشاعر، من وراء ذلك، عن نفسه. وتتحقّق آماله، ويشعرُ بالارتياح.
تكمن قيمة هذا الديوان، أيضا، في العلاقة الروحيّة التي ربطها الشاعرُ بربّه في أغلب أطوار المناجاة التي تشكّلت ورقيّا في مائة وسبعين صفحة، وزمنيّا في لحظات من العزلة والألم والعسر؛ عُسر لحظات الكتابة ومرورها مرّ السحاب، فهي قد تنثال بشكل غير متوقّع وبدون إذْن، وبشكل محدود، بدون زيادة ولا نقصان، وفي حيّز زمني قليل أيضا. إنّها أشبه بالإلهام على حدّ تعبير “ابن عربي” في كتابه “فصوص الحكم”(25). وقد أحسن الشّاعرُ التعبير عن هذا الإلهام. فقال، فاتحًا مناجاته، سالكًا في ذلك مسلكًا بنائيًّا نمطيّا ممثّلا في السرد، ساعيا، من أجل ذلك، إلى تبليغ غايات تخاطبيّة محدّدة هي توضيح ما تجلّى له لربّه:
رَبَّــاهُ
هَزّنِي الشّوقُ إليْكْ،
وَتَرَاءَتْ لِيَ
سُبُلُ الهُدَى(26)
ولأنّ الشّاعر فنّانٌ يفْنَى في محبوبه ويرى فيه ذاته، ويجعل من الشّعر، أيْ من الكتابة والخطاب، أداةً لتبليغ ما كان يَرِدُ عليه من موارد تكاد تحرقه، فإنّ هذه الكتابة قد تكتسي، ههنا، بُعدا قُدسيّا. وبالتالي فإنّها، أي الكتابة أو الخطاب، أو الإبداع على وجه العموم، قد تُصبح مرقاةً وممرّا إجباريّا(Passage obligé) لا غنى عنه لوصول الشّاعر إلى ربّه، أو بين الخالق والمخلوق وتحقيق أغراضه التخاطبيّة. وهي تجسيد واضحٌ وصريحٌ ومرتبط ارتباطا جليّا بمفهوم الخلاص(La délivrance). فمصطلح الكتابة هو، إذن، مصطلح زئبقي غير ثابت. ولئن كان هذا المصطلح في البدء رمزًا للثبات والتأبيد والتخليد، والغاية الكبرى منها تخزين أفكارَ البشر السّائبة، وعاداتهم وتقاليدهم وعلومهم ومعارفهم التي خيف عليها، في فترة من الفترات، مِنَ غلبة التّلف والضياع وسُلطان النّسيان على حدّ قول الجاحظ(27)، فإنّ باحثةً قد عدلت عن هذه الوظيفة المخصوصة التي أُنيطت بالكتابة، وبيّنت كيف أصبحت هذه الكتابة نفسها مرتبطة بالحفظ والنسيان ذلك أنّنا “نحفظ وننسى لنكتب”(28)، ونبدع.
وها هو الشاعرُ المخلوق يستعين بها، في هذا السياق، للانعتاق والانفلات من القيْد، والخلاص. فيعُطيها تصوّرا جديدا، ويصبغها بالقداسة، ويُضفي عليها مقاصد أخرى وأهداف تخاطبيّة جديدة، يقوّي من خلالها صلتَهُ بالخالق، ويُحقّق مفهوم العروج الرّوحي والارتقاء من أجل تحقيق الرضا الذي هو آخر محطة أو مرحلة، قد يبلغها السّالكُ(29). بل هو، أي العروج، “الرحلة النهائيّة للرياضيات الأخلاقيّة وتهذيب النفس“(30). يتدرّج إذن الشاعر في رحلته ولكن في أهدافه التخاطبية كذلك. وهو من وراء هذا التدرّج يريد إقناع المتلقّي(نعني ههنا القارئ الفعلي للنصّ) بنجاح رحلته ووصوله إلى الممدوح سالمًا. وهو ما تحقّق له، في الخطاب، فعلاً. يقول، سالكًا مسلكًا وصفيًّا أدبيًّا بالأساس، ساعيًا من خلاله إظهار تجاربه الخاصّة ومشاعره النفسيّة، هادفًا من وراء ذلك كلّه إلى تبليغ جملة من الغايات التخطابيّة أهمّها: الإفصاح والتأثير في المخاطب:
رَبَّـــــاهُ،
اِرْفَقْ بِعَبْدٍ
هَائِمٍ، مَهْمُومْ،
أَتَاكَ
يَشْكُو جُرْحَهُ المَكْلُومْ”(31)،
فتنجح عمليّة التخاطب، وتحقّق الغايةُ من الخطاب ومن بناء المسالك فيه. وينكشفُ الستارُ. وتزول الحُجبُ. وتسقطُ الحواجزُ. وتتجلّى الحقيقةُ السّرمديّةُ المطلقةُ. وتختفي الذاتُ الإنسانيةُ في حضرة الذات الربّانية. وتفقدُ إحساسها بالزمان والمكان، حتى تبلغ حالةً من “المحو”، وقد كانت في “صَحْوٍ”(32). هكذا هو حال المستأنس بالله. وهكذا تلتصق الكتابةُ بمعنى الطّهر، والنقاوة. وتذوب فيهما وتندرج ضمن تجربة الشاعر الوجوديّة لتعبّر عن الحقيقة السّامية المنزّهة. وهكذا، أيضا، تنتهي رحلةُ الشّاعر الصوفي المريد. ويحسُنُ ظنُّه بربّه. ويتحقّق العَوْدُ. ويُبارك صاحبُه. ويكتشف إكسير الحياة الحقيقيّ. وتنغلقُ تجربتُه الإبداعيّة بسكون تامّ، وترديدٍ دائمٍ، ويسقط حرفُ النّداء بسقوط الحواجز، ويستغني المُنادي (المخلوق) عن هذا الأسلوب ويبلغ نهاية الطريق. ولمِ الحاجةُ للنّداء، وقد تمثّل له المُنادىَ (الخالق) أمامه، وروحُه تماهت مع روحِه واندمجت؟ وهل يوجد أوضح من تشبيه الشّاعر صورته الخطابية، لحظة وصوله، بالطير الشّادي الرّوحي الحرّ ؟! قال في مقطع توّج به الشاعرُ قصيدته، وظلّ متمسّكًا فيه بمسلك بنائيّ وصفيّ أدبيّ، الذي يبدو الأقدر ههنا على تصوير حالته:
- مِنْ دَائِي
وَعُدْتُ إلى رَبِّي
- أَبَدًا
كَمَا كُنْتُ بلأْلاَءِ،
غَرِدٍ يَشْدُو
بِأَفْنَانٍ وَأَجْواءِ،
فِي ظِلِّ إِلَهٍ
وَاحِدٍ أَحَدٍ
وَنُورِ تَوْحِيد وَإِسْرَاءِ
بِتَرْديدٍ دَائِمٍ
لاَ يَنْتَهِي:
اللّهُمَّ حَنَانَيْكَ
وبِحُبَّيْكَ ثُمَّ بِحُبَّيْكْ…(33)
2- من شعريّة الخطاب إلى شعريّة التلقّي:
لا مراء في أنّ قليلا مِن البشر مَنْ يُتاح له نظم مثل هذا الضرب من الفنّ المخصوص. فالشاعرُ الصوفي لا ينظر إلى الأشياء بالنظرة نفسها التي ينظر إليها غيره ولا يشارك الشعور ذاته مع الآخرين. وشعرهُ يجيء، غالبا، بلا واسطةٍ أو تكلّف أو تصنّع وتصنيع، ولا تقليد أو محاكاة، إنّما تنثال الخواطرُ فيه دون إذن أو سابقة وفي فترات جدّ مخصوصة؛ سرّا وفي الليل غالبا. ولا غرابة في ذلك، ففي مادّة (نجا) – التي منها المُناجاةُ والنِجاءُ وهما مصدران للفعل “ناجى”- يقول صاحبُ اللّسان: إنّهما “يتطلّبان السرَّ والاعتزالَ“(34). هذه المناجاة، كما فهمها مُحلّل الخطاب ولسان العرب- تتطلّب مجهودًا بدنيًّا وطاقةً روحيّةً كبيرةً، وربّما استثنائية أحيانا. ومثلما أنّه ما كان للشاعر أن يرقى إلى السّماء بدون (آلية) الكتابة، فإنّ الكتابة هي أيضا سبيله إلى الانحدار أو العوْد إلى الأرض. وإذا كان الشاعرُ قد “لاقى” بالكتابة خالقه، فإنّه بالكتابة أيضا يُلاقي خالقَ شعره، أي مؤوّله والمتلقّي التالي في الخطاب. إنّ مفهوم التلقّي مفهوم مُتشعّب في الخطاب الصوفي، وهو مُوزّع على مصادر للتلقّي عديدة. وإنّ الكتابة ذاتها مُصطلح ثُنائيّ الوظيفة ثُنائيّ الدّلالة إذن. وهي سهمٌ، في الآن نفسه، مزدوج من حيث هو مُصوّب نحو المستقبل، وطيٌّ للزمن باتّجاه المُعاكس. وهي تستدعي، في هذا السياق، مصطلحًا آخر لا يقلّ قيمة عنها، بل هو ملازم لها ملازمة السّوار للمعصم. وهو الوجه الآخر الخفّي لها، نُريد بذلك مصطلح “القراءة”. القراءةُ والكتابةُ آليتان من آليات التلقّي والتأويل وبناء المعنى، ومتلازمتان ومتداخلتان. وعليهما يعتمد القارئُ أو المتلقّي “الثاني ” لفهم النصّ، وإعادة تفكيكه وبنائه، وإخراجه إلى الوجود، لإدراكه واستخلاص العبرة منه. ومثلما كان المتلقّي “الأوّل” للشعر الصوفي متلقيّا نموذجيّا هو الله سبحانه وتعالى، وهو مقصد الشاعرُ ومآله ومنتهاه، فإنّ القراءة سبيل التقاء الشاعر والشِّعر بالمتلقيّ الطبيعي، الذي هو من بني جنس الشاعر. أي القارئ الطبيعي “المتلصّص” الذي يظلُّ رابضًا في كلّ زاوية ما من زوايا الخطاب ومُطلاّ دائما برأسه في رحابه، ينتظر فرصته كي ينقضّ عليها. وإذا كان ناقدٌ مغربي برع في مجال السّرديات هو “سعيد يقطين” يقرّ بأنّه: “لا تلقّي بدون تأويل، ولا تأويل بدون تلقّي”(35)، فإنّه قد يجوز لنا أن نضيف إلى هذا الكلام المهمّ إنّه: “لا نصّ بدون قارئ ولا قارئ بدون تلقّي”، فالنصّ لا يكتمل بدون هذا القارئ ويضل وجوده هذا افتراضيّا.
مِنَ البيّن أنّ هذا الضرب من النظم مثلما هو يشترط نوعًا مخصوصًا من الشعراء، وكذا نوعا مخصوصًا من اللغة المصوغة، هي لغة الكشف الصوفيّة التي تضرب باللغة العاديّة صفحًا، مُقرّة بعجزها عن نقل رؤية الشاعر المريد، فنكون بذلك “إزاء وثْبة لغوية، تحقّقت بفضل التصوّف إلى مستوى التعبير الروحي” كما يقترحه محمد بنعمارة في دراسته حول الصوفيّة في الشعر المغربي المعاصر((36). هذا الضرب من الشعر يشترط، إلى ذلك، نوعًا مخصوصًا من القرّاء ولابدّ. نعني ههنا القرُّاء النوعيّن، وربّما الصّوفيين، الذين يشربون مع الشعراء مِنَ الحوض اللّساني نفسه على حدّ عبارة صاحب اللُمع(37)، القادرين على فهم الألفاظ الصّوفيّة، وتذوّقها والانزياح بها من حقلها الدّلالي الأوّل غير المراد إلى حقل ثانٍ مخصوصٍ ومُرادٍ. ومن ثمّة استنباط النظام الدّلالي المتحكّم فيه، وربط ذلك كلّه بحياة الشاعر المعيشة، المصطبغة بمشاعر العشق والتّوق، والمسكونة بهاجس الرّحيل والهجرة.
إنّ الهدفَ من هذا التبئير على فترة كتابة الشعر الصوفي وظروفها الحافّة بها، التنصيصُ على أنّ هذه الظروف المُحيطة بالشّاعر المُبدِع والعملِ المُبدَعِ قد تنعكس بصفة آليّة، وتفصح عن سلوكات الصوفي المريد، وتغذّيها. عنينا هنا، أنّ هذه المناجاة يُمكن أن تكون تجليّا فريدا لتصرفات هذا الشاعر الإنسان، وأن تكون مرآة عاكسة، وشهادةً حيّةً، ويمكن أن تجيء شاهدا على ما أحسّ به هذا الشاعرُ، أو فكّر فيه، أو آمن به، أو خاف منه. فكلّ هذه الجزئيات والتمفصلات المكوّنة لنسيج الشاعر الصوفي، لا يُمكن أن تُفهم إلاّ بتنزيلها في هذا السّياق المخصوص، وتفسيرها بالرجوع إليه وحده. وعلى ضوء هذا السّياق فقط، يُمكن أن نفهم عقليّته، وتصرّفاته، ونُعيد بناء شخصيّته، ونُعيد – في الآن نفسه- بناء مُبرّراته، ومشروعيّة قيامه بأفعال مّا، في سياق مّا، ولحظة زمنيّة مّا، وتقييمها.
الملاحظُ أنّ خصوصيّة الخطاب الشعري في هذا الديوان، باعتباره نظامًا وبنية لغويّتين فعّالتيْن، يمكن أن تُستمدّ، أيضا، من خلال تداخل خطابات عدّة فيه وبشكل واضح. وأهمّ هذه الخطابات: الخطاب القرآني ممثّلا في بعض الآيات، والخطاب الحديثي(النبوي) والخطاب الغزلي. ولعلّ في ذلك – وهذه قاعدة لا تخصّ خطاب الشعر الصّوفي فقط – أكبر دليل على أنّ أيّ خطاب لا يُمكنه أن ينشأ بمعزل عن سائر الخطابات الأخرى التي يتحاور معها ويتساند إليها، ويتطالب معها ويتداخل بشكل لا انفصام له(38). فالخطاب، بالتالي، وعلى حدّ عبارة “محمد مفتاح” هو” حصيلةٌ لكلّ ما يعلق بذاكرة الشاعر من معلومات ومحفوظات”(39).
إنّ تضمين الشاعر الصّريح لخطابات أخرى ضمن نسيج خطابه الصوفي يُبين، في اعتقادنا على أمرين رئيسيْن:
أمّا أوّلهما فهو صناعي بحت يدلّ على طبيعة المسلك التخاطبي الذي سلكه الشاعرُ في هذا المستوى من خطابه الشعري. وهو مسلك التناص الذي يعرّفه الناقد محمد يونس علي بكونه: إذابة المقتبس في بنية النصّ”(40). وهو ما من شأنه أن يسلّط الضوء على مفهوم مرتبط بصانع الخطاب ذاته، هو مفهوم (الكفاءة الموسوعيّة ( التي “تتمثل في كونها احتياطًا واسعًا للمعلومات وللمعارف والمعتقدات من خارج دائرة اللفظ، تحمل على السياق”(41) . هذه الكفاءة تجعل من صانع الخطاب محيطا بسائر ضروب القول التي سعى إلى أن يضمّها، عند الحاجة، في خطابه، واعيًا الوعي الرّاسخ، بأدوارها في خدمة المعنى وبنائه.
وأمّا ثانيهما، فهو طبيعة الخطاب المصوغ ذاته. والذي يبدو ههنا خطابًا جامعًا، أو جُماع خطابات يعُيد توزيع الخطابات داخله ويفتح المعابر بينها، فتتساند فيه هذه الأخيرة إلى بعضها البعض. وفي ذلك دليلٌ على أنّ العلاقة بين هذه الخطابات لا تقوم على التنافر والقطيعة بقدر ما تقوم على الاستدعاء والتوظيف وتبادل الأدوار للغاية نفسها. وهو ما من شأنه أن “يلفت اهتمامنا إلى التخلّي عن أغلوطة استقلاليّة النصّ“(42) على حدّ عبارة الناقد صبري حافظ، لأنّ “أيّ عمل يكتسب ما يحقّقه من معنى بقوّة كلّ ما كُتب قبله من نصوص. كما أنّه يدعوننا إلى اعتبار هذه النصوص الغائبة مكوّنات شفرة خاصّة يُمكّننا وجودها من فهم النصّ الذي نتعامل معه وفضّ مغاليق نظامه الإشاري“(43).
وبالتالي فإنّ هذا الزّحام الذي تشهده الخطابات ضمن خطاب الشاعر قد أثراه، وأضفى عليه أبعادا جمالية وشعريّة متعدّدة. ليس عجبًا إذن، والحال هذه، أن يتداخل الخطاب القرآني مع الخطاب الصوفي في هويّة واحدة مشتركة داخل هذه الأشعار، ومكتسبة من هوّيات أخرى ومقترضة من أماكن أخرى. فالخطاب الصّوفي يدور في أفق وسياق مقدّسيْن بالأساس. وهو ما يجعله قريبًا من الخطاب القرآني في معانيه، وفي ألفاظه، وفي دلالاته أيضا وفي الصُور الخطابية التي يعرضها في رحابه. وإلى ذلك، فالثقافة الصوفيّة “هي مثلها مثل الثقافة العربية برمّتها ثقافة اشتقاقية مؤسّسة على نصّ مقدّس هو النصّ القرآني على حدّ عبارة محمد عابد الجابري(44).
من خلال “مناجاة” يُمكن أن نلْحظ حضورا قويّا ولافتا لآيات قرآنية صريحة، وظّفها الشاعر ليُشبع بها خطابه، ولينقل لنا شعوره وليدعّم بها منحىً دلاليًّا محدّدا، وحوّلها من سياقها القرآني الى سياق ثانٍ صُوفيٍّ، محافظًا على تراكيبها ووظائفها ودلالاتها. ولاشكّ في أنّ لذلك كلّه شعريّة مخصوصة وحجيّةً تدفع نحو التأثير بالإيجاب على المتلقّي، نظرا لما يتميّز به الخطاب القرآني من بلاغة وقدرة على المحاججة. يقول:
هَا أَنَا عُدْتُ إليْكْ
قبْل أن تَلْتَفَّ “السّاقُ بالسّاقْ”(45)
وكان إليْكَ
“يومئذ المَساقْ”(46).
ويضيف:
رَبَّـــاهُ
“إذا زُلْزِلَتِ الأرضُ زِلْزالها”(47).
ثمّ نجده يقول:
رَبَّـــاهُ
إذا “حُصِّلَ مَا فِي الصُدُورْ”
وبُعثر ما في القُبورْ”(48).
ولم يكن تداخل خطاب الشاعر الصوفي مع القرآني تركيبيّا فقط وإنّما سياقيّا أيضا. فسِمة الحضور هذه يمكن أن تختفي، في جزء آخر من القصيدة، ويحلّ محلّها نوعٌ آخر من الحضور هو الحضور بالغياب. ذلك أنّ قارئ مناجاة يجد أنّ الشاعر يسعى فيها إلى توظيف وانتقاء تعابير لغوية ذات نفحات قرآنية، ودمجها في خطابه بثقلها الدّلالي وكثافتها الرمزيّة وإعادة إنتاجها رغبة منه في تقوية خطابه ومزيد تطعيمه. وبذلك يحضر المعجمُ القرآني بالغياب، أو هو يحضر حضورا غير مباشر من خلال استعمال بعض الكلمات القرآنية المنعزلة عن سياقها، لم يبتكرها الشاعرُ وتوحي بسطوة المعجم القرآني على ذهنه، وعلى الأفق الديني الذي تدور فيه العمليّة الإبلاغيّة برّمتها. وقد استدعاها الشاعرُ على نحو بارز، وعلى نحو تغدو معه، في سياقها الجديد، جزءا لا يتجزّأ من تجربته الشعريّة ومن صناعة خطابه. ومن الإشارات السّاطعة على ذلك ألفاظ عديد تغصّ بها “مناجاة” الشاعر نحو: الرحمة (ص،13)،النور (ص،9)، السّجود (ص،11)، التسبيح (ص،23)، الآيات (ص،33)، (ربّ المشرقين وربّ المغربين، ص،28)، ناهيك عن ذكر أسماء الله الحُسنى في مواضع عدّة. إذ قلّما خلت مقطوعةٌ من ذكر اسم من هذه الأسماء نحو: القُدّوس،(ص، 9)، القهّار (ص، 11)، الخالق، الباري، (ص 15)، الرحمان، (ص، 16)، مالك المُلك، (ص، 32). فهذه الألفاظ- وغيرها كثيرٌ في الديوان- تُبيّن سطوة الخطاب القرآني في الشعر الصوفي عمومًا.
من الخطابات المنجزة التي نجدها مبذورةً، كذلك، في “مناجاة” نجد الخطاب الحديثي. يظهر هذا الخطاب في اقتباس الشاعر للحديث النبوي الوارد في صحيح مُسلم على لسان عائشة رضي الله عنها، إذ “رأت عائشة أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقولُ في ركوعه وسُجوده “سبّوح قدّوس. ربّ الملائكة والرّوح”(49). وفي هذا السياق يقول الشاعر:
ربّــــاه
يَا قُدُّوسُ
يَا سُبُّوحْ
يا رَبَّ الملائِكة والرُّوحْ(51)
وللخطاب الغزلي نصيبٌ في “مناجاة” كذلك. إذْ يحتلّ عنصر الحبّ في الشعر الصّوفي قيمة مهمّة. والناظر في متن “مناجاة” سرعان ما يلحظ أنّ هذا السجلّ الغزلي يحتلّ فيها مكانا مكينًا ويمتدّ على طول هذه المناجاة. وهو حبٌّ متنوعٌ ومتعدّد، أحسن الشاعرُ الإفصاح عنه لغةً وإحساسًا. فالشاعر يُكثر، في مناجاته، من استعمال ألفاظ الحبّ على غرار: يا حبيبي، الشوق(ص، 5)، عاشق، (ص،8)، أشواق الهوى،(ص،10)،اشتقت إليك، (ص،18)، الحبيب، (ص،64).
ومعلوم بأنّ الحبيب العوّادي، كما الشعّراء الصّوفيين عامّة، قد انزاح في هذا السّياق بمفهوم العشق من سياقه الدّنيوي الجسماني المُدنّس إلى سياقٍ ثانٍّ روحيٍّ مُقدّسٍ، هو عشقٌ إلهيٍّ عجيب على حدّ قوله(51)، فاستعار ألفاظه، وأفرغها من محتواها التي ارتبطت به: بمرسله ومُتلقّيه، واستنبط لنفسه علائق في الحبّ جديدة، ومحبوبًا جديدا، وسلك مسالك خطابية جديدة للتعبير عنه، واتّبع قواعدَ في العشق جديدة غير متعارف عليها، وأضفى عليها إيحاءات ومعانٍ جديدة أيضا. قال الشاعر:
رَبَّــــاهُ
عَادَ الحَبيبُ
إِلَى الحَبيبْ
بِقَلْبٍ خَاشِعٍ
مُتألِّمٍ
وبشَوْقٍ دافِقٍ
مُتموّجٍ،
يهزُّ المُجَابَ
إلى المُجِيبْ،
عشقٌ صريحٌ
لاَ رَيْبَ فِيهِ،(52)
ولا شكّ في أنّ العلاقة التي وصّفناها بين هذه الخطابات لا يُمكنها، في الأخير، أنّ تحدّ من أصالة الخطاب الشعري في “مناجاة”، أو تُقلّل من قيمته وحضوره، بقدر ما يُثري تقاطعها الخطابَ وتُضفي عليه متانةً، وتفتح فيه مسالكَ جديدة للقراءة والتّأويل، الأمر الذي من شأنه أن يُظهر طرافته ويُخصّبه ويقوّي المعنى فيه، ويفتحه على قراءات للقرّاء متعدّدة.
3- بمثابة الخاتمة:
أفضى بنا هذا التحليل العَجِل لتجربة الشاعر “الحبيب العوّادي” الصّوفية إلى القول: إنّ الشّاعر قد طرق، على الصعيد الشخصي، أبوابًا طريفةً وجديدةً في الآن نفسه، ولم تكن معهودة في كتاباته السّابقة. وأمّا على صعيد البناء الفنيّ، فلقد نسج الشاعرُ هذا الضرب المخصوص من الفنّ بطريقة مغايرة، وسلك، من أجل الوصول إلى أغراضه، مسالك خطابية عديدة على نحو ما ألمعنا إليه. كما وخلّص شعره المصوغ مِنْ دوّامة الجنس الأدبي الواحد، ومزج فيه الدّيني بالدّنيوي بلغة إيقاعيّة فريدة، وتداخلت الخطابات ضمن المتن نفسه، ممّا أفقد هذا الجنس الأدبي هُوّيته وجعلته بلا هُويّة، أو متعدّد الهُويّات. على الرغم من أنّ البنية العامة للقصيدة ظلّت مُتحقّقة ومحافظة على تماسكها من حيث كونها هجرةً روحيّةً امتدّت على مراحل ثلاث: مرحلة المعاناة – مرحلة الخروج – مرحلة الوصول.
الهوامش
- الحبيب العوّادي، مناجاة، مطبعة فنّ الطباعة، تونس، 2016.
- من الأبحاث المهمّة والحديثة التي سلطّت الضوء على مسالك الخطاب نجد خاصّة:
- محمد محمد يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، نحو بناء نظريّة المسالك والغايات، دار كنوز المعرفة، الأردن، ط، 1، 2016. وينبني هذا الكتاب على فكرة أنّ أطراف العملية التخاطبيّة – متكلّمين ومستمعين- يلجؤون إلى مسالك تخاطبيّة معيّنة لتحقيق مقاصدهم وأغراضهم وغاياتهم. انظر كتابه، ص، 100. وقد أورد الناقدُ المغربي “بنعيسى عسو أزاييط” بدوره جملةً من المسالك المنهجية بين المتخاطبين. هذه المسالك هي: مسلك القول، مسلك استلزام المعرفة المشتركة، مسلك استلزام الانعكاسية، مسلك الفعل عند المخاطب. انظر كتابه: الخطاب اللّساني العربي، هندسة التواصل الإضماري من التجريد إلى التوليد، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2012ج، 2، ص، 329.
- مناجاة، ص، 5، والتشديد من عندنا.
- مناجاة، ص، 19.
- مناجاة، ص، 20.
- أبو النصر السراج الطوسي، اللمع في التوصّف، تحقيق، عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، مصر، 1960، ص، 376.
- مناجاة، ص، 11. والتشديد من عندنا.
- مناجاة، ص، 14. والتشديد من عندنا.
- مناجاة، ص، 171.
- آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقديّة المعاصرة، منشورات الاختلاف، ط، 1، الجزائر، 2002، ص، 21.
- مناجاة، ص، 173، والتشديد من عندنا.
- القرآن الكريم، سورة يوسف، آية، 53.
- مُحيْ الدّين بن العَربي، تُرجمان الأشواق، ط، دار صادر، بيروت، 1966، ص، 54.
- هذه المراتب هي: التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكّل، الرضى. انظر:
- أبو نصر السراج، اللمع، ص، 41- 54.
- محمد مفتاح، الكتابة الصوفية ماهيّتها ومقاصدها، مجلّة كليّة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، المغرب، ص، 10.
- مناجاة، ص، 5. والتشديد من عندنا.
- مناجاة، ص، 15. التشديد من عندنا.
- نسيب الاختيار، الشعر الصوفي، المكتبة الأهلية، بيروت، د .ت، ص، 37.
- مناجاة، ص، 8.
- مناجاة، ص، 14
- مناجاة، ص، 18.
- أبو عثمان عمرو الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج، 1، 1998، ج، 1، ص، 104، 105.
- J.L. Austin. Quand dire c’est faire. Trad. Gillet lane. Seuil. Paris. 1970. P.109.
- ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق، أبو العلاء عفيفي، ط،2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1980، ص، 47.
- مناجاة، ص، 5. والتشديد من عندنا.
- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، ج،1، دار الجيل، بيروت، د.ت، ص، 33.
- حورية الخمليشي، الهويّة والذاكرة ورهانات الكتابة، مجلّة يتفكّرون، مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، صيف، 2014، ص ص، 127.
- معلومٌ بأنّ الرحلة أو الهجرة تمرّ، في المنظور الصوّفي، عبر مراحل ثلاث أساسيّة هي على الترتيب: مرحلة المعاناة – مرحلة الخروج – مرحلة الوصول. انظر في هذا الصدد:
- عبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي وآليات التحويل، قراءة في الشعر المغاربي المعاصر، ط،1، الجزائر، 2008، ص، 366- 368.
- ممدوح الزوبي، معجم الصوفيّة، دارُ الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، ط،1، 2004، ص، 183 .
- مناجاة، ص، 12. ويقسّم الناقد محمد محمد يونس علي مسلك “الوصف” إلى ثلاثة أنواع. فمنه: الوصف العلمي، ومنه الوصف الأدبي ومنه الوصف الحسيّ. راجع بهذا الصدد: محمد محمد يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، ص، 124-125.
- مصطلح صوفي يعرّفه ابن عربي بأنّه “اللحظة التي يغيب فيها العبد عن عقله. انظر:
- ابن عربي، اصطلاح الصوفيّة (ضمن رسائل ابن عربي)، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط، 1، 2001، ص، ص، 410. والصحو هو : “الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة. المرجع نفسه، ص، 410.
- مناجاة، ص، 173، والتشديد من عندنا.
- ابن منظور، لسان العرب، مادة،نجا،ج،6، ص، 149.
- سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، 1، 2012، ص، 197.
- محمد بنعمارة، الصوفيّة في الشعر المغربي المعاصر، (المفاهيم والتجليات، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، 2000،ص، 48- 49.
- السراج الطوسي، اللُّمع، ص، 23.
- في تطالب الخطابات وتساندها ضمن الخطاب الواحد، راجع: محمد بازّي، صناعةُ الخطاب، الأنساق العميقة للتأويليّة العربيّة، دار كنوز المعرفة، ط،1، الأردن، 2015، ص، 236.
- محمد مفتاح، دينامية النصّ، المركز العربي، ط،1، بيروت، 1987،ص، 152.
- محمد يونس علي، المرجع نفسه، ص، 15.
- بنعيسى عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي، ج، 2، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2012، ص، 384.
- صبري حافظ، التناصّ وإشاريات العمل الأدبي، أَلِف مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، ع، 4، 1984، ص، 21.
- صبري حافظ، المرجع نفسه، ص، 21.
- محمد عابد الجابري، الفقه والعقل والسياسة، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع 24، 1983، ص، 23.
- مناجاة، ص، 20، والقرآن الكريم، سورة القيامة، الآية، 29.
- مناجاة، ص، 20، والقرآن الكريم، سورة القيامة، الآية، 30.
- مناجاة، ص، 47، والقرآن الكريم، سورة الزّلزلة، الآية 1.
- مناجاة، ص، 91.
- صحيح مسلم، دار الاعتصام للطباعة والنشر والتوزيع، 2011، ص، 229.
- مناجاة، ص، 167.
- مناجاة، ص، 39.
- مناجاة، ص، 169.
ثبت بقائمة المصادر والمراجع
المصادر:
- القرآن الكريم
- صحيح مسلم، دار الاعتصام للطباعة والنشر والتوزيع، 2011.
- العوّادي، الحبيب: مناجاة، مطبعة فنّ الطباعة، ط، 1، تونس، 2016.
المراجع:
- ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة(نجا).
- الاختيار نسيب: الشعر الصوفي، المكتبة الأهلية، بيروت، د.ت.
- أزاييط، بنعيسى عسو: الخطاب اللساني العربي، ج، 2، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2012.
- ابن عربي، اصطلاح الصوفيّة(ضمن رسائل ابن عربي)، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط، 1، 2001.
- بازّي، محمد: صناعةُ الخطاب، الأنساق العميقة للتأويليّة العربيّة، دار كنوز المعرفة، ط،1، الأردن، 2015.
- بلعلى آمنة: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقديّة المعاصرة، منشورات الاختلاف، ط، 1، الجزائر،2002.
- بن العربي، مُحيْ الدّين: تُرجمان الأشواق، ط، دار صادر، بيروت، 1966.
- بن عمارة محمد: الصوفيّة في الشعر المغربي المعاصر، المفاهيم والتجليات، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، 2000.
- الجابري محمد عابد: الفقه والعقل والسياسة، (مقال) مجلة الفكر العربي المعاصر، ع، 24، فيفري، 1983.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر:
- كتاب الحيوان، ج،1، دار الجيل، بيروت، د.ت.
- البيان والتبيين، تحقيق، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج، 1، 1998.
- حافظ، صبري: التناصّ وإشاريات العمل الأدبي، أَلِف مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، ع، 4، 1984.
- الخمليشي حوريّة: مجلّة يتفكّرون، صيف 2014، ص ص، 122،131 مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب.
- دينامية النصّ، المركز العربي، ط،1، بيروت، 1987
- الزوبي ممدوح: معجم الصوفيّة: دارُ الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، ط،1، 2004.
- السراج أبو نصر الطوسي: اللُّمع، تحقيق، عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، مصر، 1960
- هيمة، عبد الحميد: الخطاب الصوفي وآليات التحويل، قراءة في الشعر المغاربي المعاصر، ط،1، الجزائر، 2008.
- يقطين سعيد: السّرد العربي، مفاهيم وتجليات، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، 1، 2012.
- المراجع الغربية:
- Austin. J.L. Quand dire c’est faire. Trad. Gillet lane. Seuil. Paris. 1970