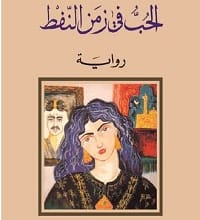بمناسبة صدور رواية “ملاوة” )2025 ( للكاتب عبد القادر فيدوح، تطلّ علينا تجربة سردية جديدة تنبض بعمق المكان وحرارة الذاكرة، وتستكشف تساؤلات الإنسان العصامي الذي شقّ طريقه بنفسه في صراعه مع التاريخ والهوية، وانزلاقات الحياة اليومية الصامتة.
في “ملاوة” لا يكتفي الكاتب بسرد الحكاية، بل يشيّد عالمًا روائيًا تتقاطع فيه التفاصيل الصغيرة مع القضايا الكبرى، حيث يتحول المكان إلى بطلٍ صامت، واللغة إلى أداة كشف وتأمل، تجمع بين الشعرية والواقعية، وبين الحنين والنقد.
“ملاوة” ليست لفظًا عائمًا، أو عنوانًا اعتباطيًا، بقدر ما هي نبع دلالي متجذّر في فضاء السيرة الأدبية؛ سيرة لا تُكتب بوصفها تسجيلاً كرونولوجيًا للأحداث chronologically ، بل باعتبارها تشكّلاً سرديًا للمعيش اليومي، حيث تتداخل الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجماعية، ويتحوّل اليومي البسيط إلى مادة أدبية كثيفة المعنى. في هذا الأفق، تغدو «ملاوة» علامة على سيرة مشبعة بالتجربة الحياتية، تستمد مشروعيتها من التفاصيل الصغيرة والهامشية، لا من الوقائع الكبرى وحدها. فهي سيرة تُعيد الاعتبار للإنسان العصامي، الذي يعيش خارج دوائر الضوء، ويصوغ هويته ووعيه من احتكاكه الصامت بالحياة، ومن طقوسها المتكررة، ومن اقتصادها البسيط في الألم والأمل.
وهكذا، تتحول «ملاوة» داخل السياق السردي إلى رمز مركزي تتقاطع فيه السيرة والخيال، والذات والآخر، واليومي والتاريخي، لتؤسس كتابة سردية تجعل من الهامش مركزًا، ومن العيش البسيط أفقًا دلاليًا لفهم الهوية والذاكرة ومعنى الوجود الإنساني.
هي رواية تنصت إلى المهمَّش، وتعيد الاعتبار للصوت الإنساني في بساطته وعمقه، وتدعـو القارئ إلى رحلة فكرية ووجدانية، لا تخلو من الدهشة والأسئلة المفتوحة.
هذه مقاطع من الرواية لك أن تختاري منها ما يناسب حجم التغطية الإعلامية
وقد جاء في تقديم الكاتب لروايته:
حين داعبني الحنين لأروي مِلاوتي، وأُفكّ طلاسم صمتي، وأسرد ملامحي المنسية، كنت أعي تمامًا أنَّ لكل لحظةٍ فيها نَبْضًا لا يُدْرَكُ كله، ولكن كان جدير بي أن أختار مما جرى ما يثمر قصدًا، ويُجدي أثرًا، ويضيء الطريق للقارئ دون أن أُحِيلَ جميع الخفايا إلى العلن؛ إذ “ليس كل ما يُعاش يُقال“. فبعض التجارب، مهما غرفتُ من نبعها العميق، تبقى عصيّة على البوح، كأنها كتبت بلغة لا تُفكُّ رموزها إلا في أروقة القلب. وما كل ما نعيشه يُروى، إذ ثمة لحظات منسوجة بأنفاسٍ موجوعة، أو نبضات خجولة تشبه وشي الهواء حين يعبر الروح دون أن يُرى. هناك، في عمق الشعور، حكايات وُلدت لتسكننا، مختومة بجمرةٍ لا تخفت، هي تلك الحكايات التي نعيشها بصمت، ونرتجف لها بارتعاشٍ لا يملكه الكلام، لأنها وُجدت لتُحسّ، لا لتُكتب، أو تُحكى؛ بل لتُعاش، اتباعًا لقول أحمد أمين في “حياتي” : لم أذكر كل الحق، ولكني لم أذكر فيه أيضا إلا الحق، فمن الحق ما يرذل قوله وتنبو الأذن عن سماعه، وإذا كنا لا تستسيغ عري كل الجسم، فكيف نستسيغ عري كل النفس؟”؛ لأن في الحياء تسكن روحٌ تتوارى عن الضوء، لا خجلاً، بل احتفاظًا بسرّها المصفّى، سرٍّ تنسجه بإرادتها، وتدفنه في الأعماق حيث لا تطاله نظرات العابرين. وربما كان النفور من الانكشاف صلاةً صامتة تُرفع لقداسة الكيان، ذاك الذي لا تدركه العيون، لأنه أعمق وأثمن من أن يُرى؛ إذ “ليس كل ما يُرى يُقال، ولا كل ما يُقال يُمنح.” هناك، في الأعماق، حيث السرّ ينمو كوردة لا تحتاج إلى ضوء النهار، يتجلى الجسدُ بوصفه معبدًا، لا جسدًا، وما الخوف من العري سوى انحناءة الوجدان أمام قدسية لا تطيق الابتذال.
في هذه الصفحات، سيعانق القارئ ما خطه اليراع وهو يرسم أولى خفقات وعيي بالحياة، نسجتها أنفاسي، وانا أفتح عينيّ على نسائم الحياة، حين بدأت أعي العالم بعينٍ دامعة ودهشةٍ عاشقة، بدايةً من انبثاق الفكرة الأولى، مرورًا بالتحديات التي قَدَّت بيني وبين تحقيق الأحلام، وانتهاءً بحصاد الخبرات التي شكّلت وعيي. ما ورد في هذه المِلاوة ليس ما يُدرَكُ من التجربةِ كلِّها، ولكنه جاء بما ينبغي أقله، لِيَكُونَ مرآة صادقة تعكس لحظات الفرح والحزن على السواء، دون إفراط في الكشف أو تفريط في الإخفاء.
سأدع لبوح اليراع ينبض بما عشته من إنجازاتٍ وانكسارات، ليصوغ على صفحات “مِلاوة” نبضَ روحٍ أرهقها الحنين، لم يعرف السأم أبدًا، بل ظل ينبض ببصيرة تبحث في صمتٍ عن ذلك الطفل الضائع… الحالم… التائه… المفقود… الحائر، الذي كان يئنّ تحت عبء الأسئلة المتناسلة: من أين انطلقتُ؟ إلى أين أمضي؟ ومن يعيد لي ضحكتي التي ضاعت، ولُعبي التي نثرتها الأيام على طرقات الغياب؟ ومن أين لي بدفء الأبوة المفقود، وعاطفة الأم التي تفرقت كالريح، القريبة البعيدة عني كنسمة لا تُمسك، وحنانها الذي تناثر من حولي دون أن يحتويني، ظلّ يلامسني دون أن يسكنني، قريبٌ كالعطر… بعيدٌ كالهواء، كظلّ حلمٍ لا يُطال، كدفءٍ عبر الروح ثم غاب، أو كنورٍ خافتٍ زار القلب واختفى.
لم يكن نزيف يَراعي هو من خطَّ ما مضى من فصول، ولا دمي المسكوب على الورق من نقش ما مضى من الحكاية، ولا قلبي هو من انتقى لحظات المجد ليعرضها على مرآة الزمن، متناسيًا ما تبقّى من العادي والبسيط، مما لا يُروى. لم أُغلق الباب على لحظات ضعفي، ولا أخفيت وجعي حين وخزني كشوكة ناعمة في لحم الذاكرة. فحتى الأقوى تعثّر ذات لحظة، وكل نبيل خذله نبضه في ساعةٍ من ساعات الحياة.
لم أكن مهووسًا بتلميع صورتي، لكنني لم أنكر أن في داخلي توقًا عذبًا لأن أكون شيئًا مختلفًا، صوتًا لا يُنسى، أثرًا لا يُمحى. لست أحتقر الحلم حين يرتدي وشاح المجد، ولا أتنكر للدهشة التي تصاحب البقاء في ذاكرة الآخرين. فما ذلك كبرياء، ولا هو جنوح إلى الغرور؛ بل هو الحزن، ذاك الحزن العميق الذي لا يُروى، حين يحدّق الإنسان في العدم، ويشتهي أن يُقاومه بالذكرى.
فليكن هذا البوح عتبةً يغادرها القارئُ إلى عوالم من الذكريات والتأملات، علَّها تتفتح أمامه أبواب سيرةٍ كتبتها أناملي، ورسمها قلبي بصدقٍ لا يتراجع عنه، كما لو كانت زهرةً تتفتح على مهلٍ تحت شمسٍ خجلى